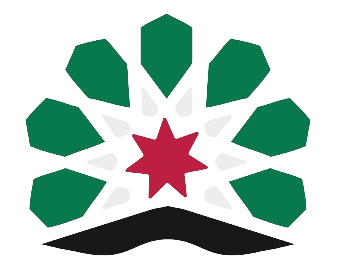بواسطة MostafaAlkhawaldeh | يوليو 23, 2024 | مقالات
هل نستطيع أن نجعل من الانتخابات البرلمانية «قضية وطنية»، تحظى باهتمامنا واحترامنا، ثم نُوجّه إليها نقاشاتنا العامة لتصحيح مساراتها، وضمان سلامتها ونزاهتها؟
أكيد، نعم، لكن هذا يحتاج إلى أن نتوافق ؛ أقصد إدارات الدولة والمجتمع بكافة أطيافه واطرافه، على عنوانين اثنين، الأول : مشروع التحديث السياسي هو مشروع الدولة للدخول إلى مئويتها الثانية، وهو يمثل الجميع، ونجاحه ضرورة وطنية، الثاني : الانتخابات فرصة للتحول نحو بناء سياسي جديد، يستند إلى مؤسسات فاعلة تحظى بثقه الأردنيين، ولكي نقتنع جميعا بنتائجها، لابد أن نضمن نزاهتها، وأن نمنع أي تدخل فيها من أي جهة كانت.
نهاية الأسبوع المنصرف، تحركت الهيئة المستقلة للانتخاب لإبلاغ النائب العام بواقعة» شبه فساد مالي «، تورط فيها أحد الأحزاب الأردنية، دور الهيئة -كما قال رئيسها، موسى المعايطه – هو تفعيل القانون لضمان أعلى درجات النزاهة، وهي تمارسه بموجب صلاحياتها، ولا تتدخل بالأحزاب وليست وصية عليها، خيرا فعلت الهيئة بالطبع، فالمزاج العام،قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات، أصبح ملبداً بالشكوك حول تسرب «المال الأسود « لبعض الأحزاب وقوائم المرشحين فيها، كان لابد من مواجهة هذه «البلوى العامة» التي يمكن، فيما لو ترسخت، أن تعصف بالتجربة في أول مرحلة من مراحلها.
أعرف، وفق معلومات مؤكدة، أن تصرف الهيئة المستقلة للانتخاب يعكس رسالة جرى تعميمها على كافة إدارات الدولة، مفادها لا احد محصن من المساءلة القانونية، ولا مصداقية لأي حزب يختبئ تحت عباءة الدعم الرسمي، أيا كان اسمه، وسيتم محاسبة كل من يدعي ذلك، الدولة بكافة إداراتها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، والانتخابات امتحان لها، وعلى ضوء نتائجها سيجري تقييم شامل لكل من شارك فيها أو أدارها وأشرف عليها، من المتوقع أن تحدث أخطاء، ومن غير الممكن استدراكها الآن بشكل كامل، لكن المهم أن تترسخ لدى الأردنيين قناعة تامة بأن هذه الانتخابات ستكون نزيهة، ولن تتكرر فيها الأخطاء التي وقعنا فيها خلال السنوات الماضية.
أفهم، تماما، أن لدى كثير من الأردنيين ملاحظات عميقة حول ما يجري على ضفاف العملية الحزبية والانتخابية؛ خذ،مثلا، إعلانات الترشح التي اغرقت العشيرة بمناخات الانقسام، وحولت المرشحين إلى ممثلين عن مناطقهم ومصالحهم لا عن الوطن، حتى أن البعض استدعى عشائره من خارج حدود الدولة ليخوض من خلالها ماراثون الانتخابات، وينتزع مقعدا في البرلمان، خذ،أيضا، ما يجري داخل الأحزاب من محاصصات بتوقيع (من يدفع أكثر )، هنا لابد من قص الشعرة التي تفصل بين الدعم المالي المشروع وشراء المقاعد، خذ، ثالثا، حالة (وأنا مالي؟) التي أصبحت مسيطرة على النخب السياسية، حيث لا يجرؤ الكثيرون على إطلاق كلمة نصيحة، أو حتى المشاركة بالنقاش العام حول الانتخابات، وما تواجه من إشكاليات.
مهما تكن ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مجمل التجربة، سواء داخل الأحزاب أو قانون الانتخاب أو العملية الانتخابية، لابد أن نتوافق على أن هذه الانتخابات فرصة لتغيير الوضع القائم وبناء وضع قادم أفضل، وعلى أنها شأن أردني لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، أو أن يمارس « الفهلوة» السياسية باسمه علينا، وعلى أن تكلفة الاستنكاف عن المشاركة فيها، أو العبث بها، تحت أي ذريعة، ستكون كبيرة، وعلى حساب مصالحنا العامة ومستقبل أبنائنا، ثم أن نتوافق على أن البعض الذين صدمنا أداؤهم، وأخجلنا سلوكهم السياسي، خاصة من قادة الأحزاب الذين لا علاقة لهم بالسياسة ولا الأحزاب، هؤلاء ستنتهي صلاحيتهم قريبا، وأقرب مما نتوقع..

بواسطة MostafaAlkhawaldeh | يوليو 23, 2024 | مقالات
بخجلٍ، وعلى استحياء، تسعى جامعات فلسطينية وعربية للالتحاق بركب “انتفاضة الطلاب” في الجامعات الأميركية والغربية، الأمر بات محرجًا للغاية، فالعون والإسناد يأتيان الفلسطينيين من على مبعدة آلاف الكيلومترات، بينما أهل الأرض والقضية، ومن خلفهم “ذوو القربى”، ما زالوا في تيهٍ وغيبوبة.. من استيقظ منهم على وقع صيحات النساء والأطفال في غزة، وجد نفسه خارج السياق، بلا حاضنة اجتماعية صلبة، وجهًا لوجهٍ أمام سلطات أمنية جائرة، وإدارات جامعية، على صورتها وشاكلتها، إلا من رحم ربي.
مع أن “انتفاضة الطلاب” في جامعات الولايات المتحدة، الممتدة بمفاعيل “الدومينو”، إلى جامعات أوروبية وغربية، تنهض أمامنا بوصفها حدثًا تاريخيًا مفصليًا، لم نرَ مثيلًا له منذ أزيد من نصف قرن، زمن ثورة الطلاب في فرنسا وأوروبا، والانتفاضة الشعبية ضد حرب فيتنام، وحركة الحقوق المدنية.
“العروة الوثقى”
يغري ذلك، على الاستنتاج بأن “طوفان الأقصى” وما أعقبه من حرب إسرائيلية همجية على غزة، قد دخلا التاريخ من بوابة المجد للمقاومين والصامدين الصابرين في غزة، وزاوية الخزي للغزاة والمستعمرين ومنتهكي القواعد الإنسانية الأساسية، أما الذين سعوا في تسفيه “الطوفان” والحطّ من قدر المقاومة، والاكتفاء بذرف دموع التماسيح على أبرياء غزة من رجال ونساء وأطفال، فقد نالهم قسطهم من العار على أية حال.
انتفاضة الجامعات الأميركية لم تكن حدثًا منبتًّا عن سياقه، فثمة صحوة بدأت منذ عدة سنوات لتيارات مدنية وليبرالية وتقدمية وحقوقية في الولايات المتحدة، توّجت بانتفاضة جورج فلويد وحراك “حياة السود مهمة” والدور المتنامي للحركة النسائية في مواجهة خطاب يميني غارق في المحافظة، يغرف أحيانًا من قواميس “قروسطية”.. بهذا المعنى يمكن القول؛ إن هذه الانتفاضة، لم تكن فعلًا مُؤسِسًا لتحولات المشهد الأميركي، بقدر ما كانت تتويجًا لمسار من التحولات، تدلل كافة المؤشرات على أنه سيستمر ويتنامى.. وبهذا المعنى تجوز المقارنة مع التحفظ، بين جورج فلويد الأميركي والبوعزيزي التونسي، فكلاهما كان غزالًا بشّر بزلزال.
و”العروة الوثقى” بين الحراك الاحتجاجي – الشبابي – التقدمي في الولايات المتحدة، وما يجري على أرض فلسطين، لم تبدأ اليوم، فقد شهدنا “إرهاصات” هذه الصلة، زمن “سيف القدس”، قبل ثلاثة أعوام، حين رفعت شعارات تربط بين حياة السود المهمة، وحياة الفلسطينيين المهمة كذلك.. لكن سيتعين الانتظار لبضع سنوات، حتى تتظهّر هذه الصلة، فتنتقل فلسطين، قضية وشعبًا وحقوقًا أساسية، من أسفل سُلم الأولويات الخارجية الأميركية، إلى قلب السياسة الداخلية، ومحور الحملات الانتخابية في “الدولة العُظمى”.
وستنهض انتفاضة الجامعات الأميركية بوصفها ثاني أكبر اختبار للمنظومة القيمية والأخلاقية لزعيمة “الغرب المتحضر” و”عالمه الحر”، وستسقط إدارة بايدن سقوطًا ذريعًا في هذين الاختبارين معًا.. سقطت في اختبار الحرب الإسرائيلية على غزة، حين انتقلت من “الانحياز الأعمى” إلى الشراكة الميدانية والسياسية في جرائم الحرب والإبادة والتطهير العِرقي الإسرائيلية.
عنصرية واستعلاء
وسقطت حين أطلقت آلتها القمعية ضد خيرة طلبتها في خيرة جامعاتها، فكانت صور الانقضاض على الطلبة والأساتذة الجامعيين، شبيهة بصورة فلويد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، تحت قدمَي رجل أمن مدجج بالاستعلاء والعنصرية.. إلى أن جاء تقرير “الواشنطن بوست” بالأمس، ليكشف عن 900 طالب معتقل في غضون الأيام العشرة الأخيرة، وهو رقم قياسي حتى بمعاييرنا نحن أبناء “صحراء الديمقراطية القاحلة” جنوب وشرق المتوسط.
أيًا يكن من أمر، فإن ما يجري اليوم في جامعات الولايات المتحدة والغرب عمومًا، يعيدنا إلى ما ذهبنا إليه قبل عدّة سنوات، حين لفتنا إلى أن عودة الروح للحركات الاحتجاجية في الغرب، على خلفية مناهضة العنصرية والعداء للأجانب والمهاجرين واليمين الشعبوي، توفر فرصة للفلسطينيين لنقل كفاحهم ضد الاحتلال و “الأبارتيد” إلى الساحة الدولية من جديد، ولكن من بوابة الشعوب والمجتمعات والحركات التقدمية هذه المرّة.
اليوم، جاء هذا الربط بمبادرة من طلبة الجامعات الأميركية، الذين يندمج حراكهم التضامني مع شعب فلسطين، بكفاح أوسع وأشمل، من أجل استعادة قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في بلدانهم، في مواجهة تيارات ظلامية، تتلطى خلف نزعات شوفينية وتمجد التفوق العرقي للرجل الأبيض.
في هذا الصراع، تتموضع فلسطين في الجانب الصائب من التاريخ، وتقبع إسرائيل في الزاوية الخاطئة منه، معزولة ومُجرّمة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية، بل إن دورها ككابح للحريات في الغرب، يبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى، فـ “المكارثية” أطلت بوجهها القبيح في عدد من عواصم الغرب، وليس في واشنطن وحدها، وحرية التعبير تقف مكبّلةً عند خطوط حمراء فرضتها النخب الحاكمة ومؤسسات صنع القرار وجماعات الضغط والابتزاز، وجميعها مصممة لتسييج كيان الاحتلال والعنصرية وحمايته من أسهم النقد والإدانة والاحتجاج.. يتظهّر دور إسرائيل في الغرب، كما ظل دورها في الشرق، كعقبة كَؤُود في وجه الحرية والديمقراطية.
لقد جادل الغربيون طويلًا، لا سيما منذ انطلاق “عملية برشلونة” وبالأخص، في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، بأنكم – أيها الإصلاحيون العرب – قد جعلتم من إسرائيل “شمّاعة” تعلّقون فوقها أسباب إخفاقاتكم المتلاحقة باللحاق بموجات الديمقراطية المتعاقبة التي ضربت العالم على مراحل، فما شأن إسرائيل بانحباس مسارات الإصلاح والتحول الديمقراطي في العالم العربي؟
تفوق زائف
اليوم، ومن دون أن نسقط الأسباب والسياقات الداخلية للاستعصاء الديمقراطي في العالم العربي، فقد بتنا نتوفر على ما يكفي من التجارب والشواهد، للقول بأنكم أخطأتم ونحن أصبنا، فلقد رأينا بالأمس، كيف “استنفر” العالم ضد نتائج انتخابات حرة ونزيهة في فلسطين عام 2006، لأنها لم تكن متناغمة مع هندسات أوسلو ومسارات دمج إسرائيل في المنطقة.. ورأينا انقلاباتكم على ثورات الربيع العربي، لأنكم استشعرتم بغرائزكم الاستعمارية الحاكمة، أن الديمقراطية في العالم العربي، هي نقيض مسارات التطبيع والهيمنة الاستعمارية، وها نحن نرى اليوم، رأي العين، كيف أنكم تقفون على أتم الجاهزية والاستعداد للتخلي عن قفازاتكم الحريرية حين يتعلق الأمر بالدفاع عن “قاعدتكم المتقدمة”، حتى وإن اقتضى استخدام القبضة الحديدية ضد طلبتكم وجامعاتكم وشوارعكم الغاضبة.
العنصرية بحكم طبيعتها، عابرة لخطوط وخرائط الأديان والقوميات والإثنيات. وكفاح الفلسطينيين ضد العنصرية في طبعتها الصهيونية الأكثر بشاعة وانحطاطًا، بات اليوم، جزءًا عضويًا من كفاح عالمي ضد كافة المظاهر والتيارات والسياسات والممارسات المفضية للتمييز والاستعلاء والتفوق الزائف، والتطرف اليميني في طبعاته الأكثر فجاجة في عدائها للآخر والأجانب والشعوب المغلوبة على أمرها.
مقاومة التطبيع
وهذا يملي على الفلسطينيين ونخبهم الطليعية وضع الإستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتعميق هذا الربط، وتعظيم هذا الرهان، فتلكم نافذة عريضة فتحت في جدار الانسداد الذي لفّ فلسطين قضية وشعبًا وحقوقًا طويلًا.. وهذه هي الضمانة لديمومة هذا الحراك التضامني ومأسسته، وهذه هي الطريق الأقصر، لنزع “الشرعية” عن إسرائيل، وتجريدها من لبوس تدثرت به زيفًا، لأكثر من سبعة عقود، وفي ظنّي – وليس كل الظن إثم – أن هذه واحدة من أهم وأخطر “مهددات الأمن القومي الإسرائيلي”.
وفي المقلب الآخر، على الساحة العربية، يتعين على هذه النخب، تكثيف الجهد لاستحداث الربط المحكم، بين مقاومة التطبيع، وحاجة شعوب الأمة العربية لشق طرقها نحو الحرية والاستقلال والانعتاق من نير القمع والتخلف المتحكم بمصائرها ومستقبل أجيالها، فالكفاح ضد التطبيع، ليس فعلًا تضامنيًا مستحقًا مع الشعب الفلسطيني فحسب، بل هو جزء من كفاح مستحق كذلك، من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم لهذه الشعوب.. ومما لا شك فيه أن إبراز المصالح الوطنية لشعوبنا في مقاومة التطبيع، والتشديد عليها، هما الضمانة لاستنهاض حركات المقاطعة ومقاومة التطبيع، تمامًا مثلما هو الحال مع حركات الاحتجاج الطلابية والشعبية في عواصم الغرب ومجتمعاته.
انتفاضة الطلاب في الجامعات الأميركية والغربية، فاتحة لصفحة جديدة في كفاح الشعب الفلسطيني، وبارقة أمل بانتقال مفاعيل “مبدأ الدومينو” إلى جامعاتنا ومجتمعاتنا العربية، وتلكم واحدة من “بركات” الطوفان والصمود الأسطوري لغزة ومقاومتها.

بواسطة MostafaAlkhawaldeh | يوليو 23, 2024 | مقالات
بالرغم من أنّ الحرب العسكرية المباشرة، وما تتضمّنه من إبادة، تجري في قطاع غزّة، وبالرغم من أنّ الرهان على انفجار الأوضاع في الضفة الغربية والوصول إلى المواجهة المباشرة لم يتحقّق، لكن ذلك لا يعني أنّ الأوضاع في الضفّة الغربية ليست على حافَة الهاوية أو أنّها هادئة وساكنة، بل من الواضح أنّ الطائرات الإسرائيلية تقصف في غزّة ورفح، وتقتل الفلسطينيين هناك وتشرّدهم وتجوّعهم، لكنّ أعينهم هي على الضفّة الغربية التي تمثّل استراتيجياً ورمزياً قيمة أكبر بكثير، ليس فقط لليمين الصهيوني والديني هناك، بل حتّى للاتجاه الغالب من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية التي لا تملك تصوّراً استراتيجياً للمستقبل سوى تفريغ القدس والضفّة من السكّان، أو في الأقلّ استمرار التضييق عليهم وبناء المستوطنات، والمضي في خطّة الترانسفير في المدى الطويل.
قبل أيام، كشفت تسريبات لوزير مالية الكيان المُتطرّف، بتسلئيل سموتريتش عن خطط إسرائيلية سرّية لجعل كلّ المستوطنات شرعية، ولضمّ الضفّة الغربية إلى إسرائيل، وهو سيناريو لا يَشكّ، إلّا من في عينيه رمد، في أنّه قادم ومتسارع على قدم وساق، وأخذ منحىً جديداً وخطيراً منذ أحداث 7 أكتوبر (2023)، ويمثّل اليوم المثال الأبرز على عدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967.
هنالك اتجاه يدفع نحو الانتقال إلى دعم حركة حماس، والتخلّي عن فكرة دعم السلطة الفلسطينية، أو في الحدّ الأدنى، “تنويع الخيارات الاستراتيجية الأردنية” في ما يتعلّق بالضفّة
هل خطر التهجير قائم ومحتمل من الضفّة الغربية باتّجاه الأردن أم لا؟ وماذا نفعل لحماية المصالح الوطنية الأردنية والأمن الوطني في مواجهة مثل هذا السيناريو إن حدث؟ وكيف نُعرّف السياسة الأردنية تجاه الملفّ الفلسطيني بناءً على هذه الأخطار والتهديدات؟ هل يكتفي الأردن بدعم السلطة الفلسطينية أم تكون لديه مقاربة تداخلية أكثر وأعمق؟ أم يفتح خطوطاً مع حركة حماس؟ وماذا عن تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية نحو الضفّة الغربية؟ وماذا عن محور الممانعة والتصريحات الإيرانية المعادية للأردن؟ وكيف يمكن أن يتغافل الأردن عن مسألة الحدود الشمالية، وما تشكّله مليشيات إيران من خطر على الأمن الوطني الأردني شمالاً، من خلال شبكات تهريب المخدّرات أو خدمة النفوذ الإيراني؟ وكيف يعيد مطبخ القرار في عمّان صياغة التهديدات والتحدّيات على الحدود الشمالية والغربية من خلال معادلة واحدة متكاملة، تتضمّن مُحدّدات واضحة للأمن الاستراتيجي الأردني؟ أم يفصل بين المعادلتَين بما يتناسب مع حيثيات كلّ منهما؟
هذه هي الأسئلة الجوهرية التي تُطرح علناً وفي الدوائر المُغلقة في عمّان. وبالضرورة لسنا أمام اتّجاه واحد في الإجابة عنها، لا في ما يتعلّق بالنُّخَب السياسية عموماً، ولا حتّى في أروقة الدولة ونُخَبها السياسية أو المُقرّبين منهم، فهنالك اتّجاه محافظ تقليدي يضغط باتجاه عدم انخراط الأردن أكثر في أيّ مستوى من المستويات في الملفّ الفلسطيني، خاصّة ملفّ الضفّة الغربية، وإعادة تعريف مفهوم الوصاية الأردنية على القدس والمُقدّسات، بما لا يتجاوز الجانب الخدماتي الرعائي، حتّى لا يحمل الأردن فوق ما يحتمل، ويتجنّب الصدام المباشر مع المؤسّسات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وهنالك اتجاه يدفع نحو الانتقال إلى دعم حركة حماس، والتخلّي عن فكرة دعم السلطة الفلسطينية الهزيلة والضعيفة، أو في الحدّ الأدنى، “تنويع الخيارات الاستراتيجية الأردنية” في ما يتعلّق بالضفّة الغربية، وهنالك اتّجاه ثالث يقف بين الاتجاهين السابقين، ويرى ضرروة إعادة صوغ الأسئلة وطرح النقاشات بصورة عقلانية واقعية، وليس بناءً على أحكام وفرضيات مسبقة غير مُختبَرة في ما يتعلّق بالمصالح الأردنية الاستراتيجية في الملفّ الفلسطيني عموماً.
بالضرورة، من الخطأ استعجال حسم مثل هذا النقاش أو الإجابة عنه بفرضيات جاهزة، فالمسألة في حاجة إلى حوارات مُغلقة مُعمّقة في دوائر القرار في عمّان، وبين النُّخَب السياسية، والوصول إلى تصوّر استراتيجي عميق بشأن الاحتمالات المُستقبلية والخيارات الأردنية، وصولاً إلى خطّة عمل أردنية قادرة على فكّ شيفرة البيئة الإقليمية المُعقّدة التي يعيش فيها الأردن، واجتراح سياسات وبرنامج عمل يعكس القيم الوطنية الأردنية (التي يُشكّل البعد القومي – الإسلامي جزءاً أساسياً فيها)، وحماية المصالح الوطنية الأردنية واعتبارات الأمن الوطني، وإدراك، قبل هذا وبعده، أهمّية قراءة (وتحليل) المُتغيّرات الدولية والإقليمية المُختلفة، وانعكاساتها في ملفّ العلاقة الأردنية – الفلسطينية.
تأسيساً على هذه المُقدّمة، من الضرورة الوقوف عند ثوابت الموقف الأردني والمصالح الوطنية الاستراتيجية الأردنية في ما يتعلّق بالملفّ الفلسطيني أولاً، وبالوضع في الضفّة الغربية والقدس ثانياً. الاعتبار الأول المفترض أن يُحسم قبل مناقشة أيّ موضوع آخر يتمثّل في أنّ سيناريو عودة الحكم الهاشمي إلى الضفّة الغربية وإحياء هذه العلاقة، التي انتهت عملياً بمؤتمر الرباط في 1974، ورسمياً بقرار فكّ الارتباط في 1988، أمر غير وارد، ولا يخدم المصالح الوطنية الأردنية والمصالح الوطنية الفلسطينية. ومن المعروف أنّ الالتباس في موضوع “وحدة الضفّتَين” قد جرّ على الطرفَين مشكلات عديدة كبيرة، ووتّر العلاقة فترة طويلة بين الأردن ومنظّمة التحرير الفلسطينية، ولم تكن هنالك قوى سياسية فلسطينية نافذة موافقة على قرار الوحدة في 1950، بل اعتبرته جزءاً من المؤامرة على الهوية الوطنية الفلسطينية. ومن ثم، أيّ حديث أميركي وإسرائيلي، أو حتّى عربي، عن عودة الأردن بأيّ شكل إلى الضفّة الغربية هو سيناريو مرفوض بوضوح من نظام الحكم، خاصّة الملك، أو حتّى من الرأي العام الأردني، الذي يرى في هذا إتماماً لمخطّط وعد بلفور بتفريغ فلسطين من الفلسطينيين، وإلحاقهم بشرق الأردن، وصولاً إلى “الوطن البديل”، بل “النظام البديل”، فهذا هاجسٌ حقيقي واضح وبيّن لا يمكن تجاوزه أو تخطّيه.
وللتذكير فقط، رفض الملك الحسين، كما يُؤكّد مارتن أنديك، في كتابه “سيّد اللعبة: هنري كيسنجر وفن الديبلوماسية في الشرق الأوسط” (ترجمة ياسر محمد صديق، دار نهضة مصر، القاهرة، 2023)، في 1974 الخطّة التي عرضها الإسرائيليون بحكم أردني على التجمّعات السكّانية، وليس على الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، فمثل هذا السيناريو مرفوضٌ تاريخياً أردنياً. وحتّى وقت قريب، قال سياسيون أميركيون إنّ الرئيس الأميركي السابق (وربّما اللاحق) دونالد ترامب مارس ضغوطاً على الملك عبد الله الثاني من أجل القبول بدور أردني في الضفّة الغربية، وقد رفضه الملك، بل أكثر من ذلك، يقول أحد المقرّبين من الملك إنّه “إذا كان الملك الحسين، لأسباب تاريخية، كان يرى إقامة الدولة الفلسطينية خطراً على الأردن، فإنّ الملك عبد الله الثاني يرى العكس تماماً”.
الاعتبار الثاني، أنّه رغم ما ورد سابقاً، فإنّ ابتعاد الأردن أو تحجيم دوره في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية والدفاع عن المصالح الوطنية الفلسطينية أمر مرفوض أيضاً، وغير واقعي، ولا منطقي، ويضرّ بالمصالح الوطنية الأردنية لكمّ كبير من الاعتبارات والأسباب، في مُقدّمتها أنّ هنالك علاقة جدلية تاريخية ترابطية بين الضفّة الغربية والقدس والأردن، وأنّ مُخرجات ما يحدث في فلسطين ستنعكس تماماً على الأردن (كما حدث في اللجوء الفلسطيني في 1948 و1967)، ولأنّ هنالك اعتبارات ديمغرافية داخلية مترابطة بالملفّ الفلسطيني. وفوق هذا وذاك، تمثّل القضية الفلسطينية ورقة استراتيجية مُهمّة في المنطقة، وعلى الأردن أن يتعامل مع ذلك، إذا أراد أن يضع هذه الورقة في مصلحته أو أن تكون مصدر تهديد وتخويف له فقط. أمّا نظرية التقوقع والابتعاد فهي غير مُجدية في الحدّ الأدنى، فضلاً عن أنّها تؤدّي إلى الإضرار الشديد بالأمن الوطني الأردني والمصالح الاستراتيجية الأردنية. من الضروري أن يُعاد تعريف المجال الحيوي للأمن والمصالح الاستراتيجية الأردنية لتكون الضفّة الغربية جزءاً من هذه الاعتبارات، وألّا نتخيّل أنّ هنالك إمكانية لانفصال كامل أردني عما يحدث في الضفّة، فهنالك ما تزال ملفّات القدس واللاجئين والحدود والمياه، تشبّك المصالح الأردنية بالفلسطينية بقوّة.
يتمثل الاعتبار الثالث في أنّ القلق تجاه خطر “الوطن البديل” أو “الترانسفير” لا يقتصر على مُخرجات الحرب الحالية، أو في المدى القصير، ومن ثم، يصبح النقاش خارج السياقين، التاريخي والموضوعي، الصحيحين له، فمن الواضح أنّ “الخيار الأردني” لحلّ مشكلة الديمغرافيا الفلسطينية، وما ينتج عنه من آثار كبيرة في الحالة الأردنية، هو الخيار الاستراتيجي الإسرائيلي، عاجلاً أم آجلاً. ومن ثم، يصبح من العبث والملهاة مناقشة فيما إذا كان سيقبل الفلسطينيون في الضفّة الغربية بالترحيل أم سيصمدون، ما دام الحديث عن المدى القصير، بينما يشدّ الكيان الإسرائيلي الحبل حول عنقَي الضفّة والقدس بصورة متتالية، ويخنق فرص الحياة الممكنة والطبيعية، ويستثمر أيّ أزمة أو مشكلة لتعزيز هذا الحصار، وصولاً إلى اللحظة المناسبة، ويكفي أن نرصد السياسات الإسرائيلية في عملية تهويد القدس أو الاستمرار في العملية الاستيطانية، وغيرها من سياسات متكاملة مدروسة استراتيجية، تسير جميعها نحو هدفٍ واحد. من الضروري استراتيجياً، أن يكون لدى الأردن والفلسطينيين تصوّرات واضحة ومعمّقة حول الخطط والسيناريوهات الإسرائيلية في ما يتعلّق بمستقبلَي الضفّة والقدس، والعمل لبناء مقاربة مضادّة للمقاربة الصهيونية بما يحمي الوجود العربي الفلسطيني في القدس والضفّة الغربية، ليس من زاوية أمنية أو عسكرية فقط، بل الأكثر أهمّية سياسياً واقتصادياً وثقافياً، لأنّ هذه العوامل مشتركة هي مقوّمات الصمود أو الانهيار. في لقاءات مُغلقة، عقدها معهد السياسة والمجتمع مع نُخَب قيادية فلسطينية في الضفة الغربية والقدس، كان من الواضح أنّ هنالك تحدّيات ومصادر تهديد كبيرة وخطيرة مُستجدّة تندرج ضمن مخطّط إسرائيلي طويل الأمد، لعملية التهويد والسيطرة على الأرض وطرد السكّان، فهنالك التحوّل في السلوك الاستيطاني نحو العدائية والهجوم وتهديد الأمن اليومي، وهنالك الأزمة الاقتصادية الكبيرة، التي يعيشها جميع سكّان الضفّة، وهنالك سياسات تهويد القدس المُستمرّة، وغيرها من تحدّيات، تتطلب تصوّرات واقعية وعملية لمواجهتها.
هنالك قناعة لدى المسؤولين الأميركيين، منذ احتلال إسرائيلي لأراضي الضفّة والقدس، بأنّ إسرائيل لن تنسحب من الضفّة، وتريد فقط التخلّص من التجمّعات الفلسطينية السكّانية
الاعتبار الرابع، أنّ الرهان على التسوية السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية لم يعد قائماً، وفي الحقيقة لم يكن قائماً في أيّ وقت مضى. ولو عدنا إلى كتاب “سيد اللعبة” لأحد أبرز الدبلوماسيين الأميركيين، مارتن أنديك، لوجدنا بوضوح أنّ هنالك قناعة لدى المسؤولين الأميركيين مُبكّرة، منذ احتلال إسرائيلي لأراضي الضفّة والقدس، أنّ إسرائيل لن تنسحب من الضفّة، وأنّها فقط تريد التخلّص من التجمّعات الفلسطينية السكّانية، ويروي المستشار السابق للملك الحسين، ووزير الإعلام الأردني الأسبق، عدنان أبو عودة، أنّه عندما التقى وزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، في المرحلة الأولى من عملية السلام في مدريد 1991، سأله إن كانت الولايات المتحدة ستقبل بالدولة الفلسطينية، فكان جواب بيكر: “أكثر من حكم ذاتي وأقلّ من دولة”، وهذا العرض لم يعد قائماً، مع تغيّر موازين القوى المُرعب، الذي حدث في النظام العربي وقواعد الدعم الإقليمية للفلسطينيين، وآخر ما تحصّل عليه الفلسطينيون، وأفضل ما يمكن أن يُقدّم لهم، كان من خلال ما عرضه في 2014 وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولاحقاً ترامب، فيما يُعرف بصفقة السلام، وكلّها لا تصل إلى تلبية الحدّ الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
ما العمل؟ وكيف نواجه التحدّيات؟… وفقاً للاعتبارات السابقة، هذا هو السؤال المفروض أن يطرح أردنياً وفلسطينياً، قبل القفز إلى الأحكام والمواقف المتصلّبة هنا أو هناك.

بواسطة MostafaAlkhawaldeh | يوليو 23, 2024 | مقالات
نذهب إلى مهرجان جرش أم نقاطعه؟ أرجوك لا تستغرب هذا السؤال، ففي سوق «المزاودات» الذي انتصب في بلدنا، منذ أشهر عديدة، وتزاحم فيه الشطّار والمتفرجون، سمعنا ما هو أغرب، وربما نسمع في الأيام القادمة المزيد من العروض والغرائب، القصة -بالطبع – ليست مهرجاناً مضى على انطلاقه أكثر من 40 عاما، ولا تضامنا مع غزة كان الأردنيون، بلا استثناء، عموده وخيمته، المهرجان مجرد «رمانة «، لكن القصة «قلوب مليانة»، تسعى لهزّ ثقة الأردنيين بدولتهم، وتشويه صورتها، وتدفع بما لديها من قوة لكي نطأطئ رؤوسنا، ونسير على سكتها المرسومة.
هل تذكرون حادثة «الإضراب» حين تمّ إشهار الدعوة إليه من مجهولين، ثم تلقاه البعض في بلدنا بالاحتفاء والترحاب، هل تذكرون حملات المقاطعة التي تلبست «قميص عثمان»، وضربت، ولا تزال، اقتصادنا باسم الدفاع عن أهلنا في غزة؟ إذا فتحنا ذاكرتنا الوطنية على وقائع وصور عديدة حفلت بها شوارعنا ومنصات نقاشاتنا، خلال تسعة أشهر منصرفة، ربما نفهم ما يدور حولنا، وفي داخلنا، أكثر وأكثر، الذين تقمصوا الحرب واستنفروا لإلحاقنا بها، والآخرون الذين لا يسعدهم أن نظل واقفين على أقدامنا، ما زالوا يصرون على اختطاف أي إنجاز حققناه، او يمكن أن نحققه، يريدون، فقط، أن نخضع لشروطهم، او أن نبقى غارقين في السواد العام.
وقع مهرجان جرش بين فكي كماشة واحدة: فكّ دعاة التحريم باسم التدين المغلوط الذين اختزلوه في الرقص والطرب، ووسموه بالفسق والفجور، وفكّ دعاة التجريم باسم السياسة المغشوشة الذين جردوه من إنسانيته ووطنيته، وتنازعوا على هويته، واستخدموا الهجوم عليه وسيلة للمقايضات ودغدغة المشاعر، غاب عن هؤلاء وهؤلاء أن المهرجان يعبر عن وجدان الأردنيين وثقافتهم وموروثهم الحضاري، صحيح ربما نختلف على بعض فعالياته، أو أسماء بعض ضيوفه (وقد فعلت ذلك مرارا) لكن لا يجوز أن نختلف على أنه أصبح إنجازا فنيا وثقافيا أردنيا، كما لا يجوز أن يُسقط عليه البعض أجنداتهم الدينية أو السياسية للتحريض على مقاطعته او إلغائه، أو أن يتعاملوا معه، ومع مجتمعنا، وكأنهم حرّاسٌ على قيمه وأولوياته.
ارفعوا عن الأردنيين وصاياتكم، واتركوا لهم أن يقرروا، فهذا مهرجانهم، يمكن أن يذهبوا لحضور فرقة «صول « القادمة من غزة، أو حفلة تعيد لذاكرتهم فارس عوض أو متعب الصقار او حبيب الزيود، يمكن أن يفضلوا الاستماع لأمسية شعرية أو مسرحية، محاضرة في الفلسفة أو الأدب، أغنية وطنية أو ندوة فكرية، أو يتجولوا في ملتقى الفن التشكيلي، أو معرض النحت الدولي، أو يتابعوا «بشاير جرش» للمبدعين الشباب، يمكن أن يساهموا، أيضا، بدعم أهلنا في غزة من خلال شراء تذكرة دخول، أو حضور فعالية، كما يمكن أن يشتروا من ساحاته ثوبا او لوحة من صناعاتهم الثقافية.
هذه الدورة (38) تبدو مختلفة تماما، يُصفّق فيها الأردنيون لثقافتهم وهويتهم الأردنية المفتوحة على العروبة والإنسانية، ويحتفلون بتاريخهم وإنجازات بلدهم، ويتذكرون رموزهم الذين رحلوا وتركوا بصماتهم على تراب وطنهم العزيز، كما أنهم يفتحون أذرعتهم لاحتضان أهلهم الصامدين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا والعراق، وأكثر من 40 بلدا في العالم، ليردوا عليهم تحية الصمود والاعتزاز، ويتبادلوا معهم إنجازاتهم وإبداعاتهم، وهي فرصة للمثقف والفنان، في عالمنا العربي، لجمع الكلمة، وفعل ما عجزت عنه السياسة.
صحيح، المزاج العام مضطرب بما يكفي لمطاردة أي صوت للفرح والبهجة، لكن ما علاقة المهرجان بالموت الذي يحاصرنا من كل اتجاه؟ في هذا اليوم الذي أكتب فيه مقالي، انتقل إلى رحمة الله تعالى نحو 100 أردني (يبلغ عدد الوفيات سنويا في الأردن من ,30,000 إلى 36,000) لم تتوقف الحياة، ولن تتوقف، من قال إننا حين نمارس حياتنا نرقص على أجساد أو أرواح أحباء لنا رحلوا؟ الانتصار في الحياة، وفي الحروب أيضا، يستمد مشروعيته من قدرتنا على الصمود، لا الاستسلام للعجز، ومن وعينا على الواقع، لا الاستغراق بالماضي، ومن إصرارنا على البناء، لا الترويج للهدم والدمار.
من سوء حظنا أن تلعب بنا السياسة والثقافة الساخطة عليها، ومن يدور في فلكهما من الانتهازيين، أو الباحثين عن دور البطل، لنصبح مجرد صدى لخصوماتهم او أجنداتهم، لكن جرش -كما هي عمان وأخواتها – ترفض أن يخضع مهرجانها للمزايدات، فهو جزء من مسيرة الدولة وإنجازها، والنقاش حوله، وليس التحريض عليه، شأن للأردنيين الحريصين على بلدهم، لا الآخرين الجاهزين للهجوم عليه، بمناسبة مهرجان، أو بدون مهرجان.

بواسطة MostafaAlkhawaldeh | يوليو 23, 2024 | مقالات
لم تعد الحياة السياسية في الأردن، كما كانت في أوقات سابقة، وما يمكن قوله بكل صراحة ان الحياة السياسية هنا باتت باهتة وغير منتجة إلى حد كبير لاعتبارات مختلفة.
في مرحلة التسعينيات في الأردن كانت لدينا صحافة مؤثرة جدا، وذات سقوف مرتفعة ومسؤولة في الوقت ذاته، ولدينا أحزاب ذات مذاق سياسي، ونواب تهابهم الحكومات، ومن الوان واتجاهات مختلفة، ولدينا نقابات فاعلة، يحسب لها الجميع حسابا، ومؤسسات مجتمع مدني منطقية ومعقولة تعمل في مجالات شتى، ولا يمكن الغمز من قناتها، أو من مرجعياتها، وكل هذه التنويعات في المشهد، لم تهدد الأردن على المستوى الداخلي، بل عززت استقراره.
تغير المشهد اليوم كليا، إذ أن كل “المؤسسات الوسيطة” ان جاز التعبير بين الدولة والناس، تراجع دورها، وأغلب الأجسام السياسية التمثيلية باتت ضعيفة، في ظل ندرة النخب الفاعلة، وفي ظل إعادة هندسة الحياة السياسية، بوسائل مختلفة، أدت إلى هذه التراجعات، وفي ظل انفضاض كثيرين عن فكرة الترشح والعمل في مؤسسات مختلفة، بسبب شيوع اليأس.
مناسبة هذا الكلام ترتبط بالتوقعات حول البرلمان المقبل، ومن المؤكد هنا أن لا مفاجآت من نوع ما ستحدث، فهذا هو “البيدر وهذا هو قمحه”، بعد أن تم استنبات نخب “معدلة جينياً”، وتغيير قواعد إنتاج الممثلين ليس على مستوى البرلمان وحسب، بل على مستوى كل المؤسسات التي سبق ذكرها، عدا بعضها، في سياقات تخفض التأثير، ربما من باب الغاء المنافسة مع مؤسسات القرار-وهي منافسة غير موجودة بالمناسبة- أو خفض المناددة، أو التخلص من الصداع، بسبب كثرة الأزمات التي لا تحتمل أي مناوشات داخلية.
تسمع عن أسماء مهمة تنسحب من سباق الترشح من النيابة، عبدالكريم الدغمي، أيمن المجالي، خليل عطية، ولكل واحد تجربته وتأثيره، وقد تتفق معهم وقد تختلف، وقد يمثلك بعضهم، وقد لا يمثلك، لكنهم بالتأكيد اسماء وازنة، وبعضها يعد بيوت خبرة في الحياة السياسية والبرلمانية، وبعيدا عن الخوض في التوقعات حول أسباب عدم ترشح هذا أو ذاك، لان لكل اسم ظروفه الخاصة، فإننا على الأغلب لسنا أمام عملية استبدال للنخب بنخب جديدة أكثر فاعلية، بقدر كوننا نخسر هذه الأسماء، وربما غيرها، في سياقات إنتاج مشهد جديد، بمواصفات يمكن توقعها بشكل مسبق، مع الإشارة هنا إلى أن شؤون الأردن واستدامته لا تتوقف نهاية المطاف عند شخص، أو اسم، لأن الأردن هو الباقي، والأسماء متغيرة بطبيعة الحال، كما شهدنا طوال المراحل الماضية على مستوى حياتنا.
ما يراد قوله هنا انه ليس من المصلحة إضعاف كل هذه المؤسسات، ويجب أن تبقى قوية بوجود حريات تعبير إعلامية مصانة ومهنية وأخلاقية ووطنية، وان تعود عمان الرسمية لاحتمال الصداع، لان كل هذه المؤسسات داعمة للدولة، أصلا، وليست مضادة لها أساسا، مثلما أن قوة هذه المؤسسات يجعلها الموكلة شعبيا للتعبير عن القلق بطرق راشدة، أو عن أي مواقف اعتراضية من خلال القنوات المتاحة دستوريا وقانونيا، بدلا من ترك المواقف الاعتراضية ليتم التعبير عنها بشكل فوضوي في الشارع، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا، خصوصا، ان هذه المؤسسات تمثل أيضا تنوعاً طبيعيا كما هو الأردن، وتعد جدار حماية لا يجعل طرفي المعادلة، أي الدولة والناس وجها لوجه، لاي سبب كان، بما يعزز الثقة.
لا تجد اليوم اسماء مؤثرة ولا موثوقة مثل سنين سابقة، على المستوى السياسي، وقد لا تجدها أيضا على المستوى الاجتماعي، وهذا الاضعاف شمل حتى المخاتير ونوابهم، وكأننا صرنا نستبدل القوي المؤثر والحليف في حالات الخطر، بالمطيع الضعيف، الذي يفضل النجاة بنفسه فقط، ولا ينفعنا لا في السلم ولا في الحرب، ولا بينهما ايضا.
يستحق الأردن، مؤسسات تمثيلية فاعلة تليق بشعبه، وبقدرتهم الخلاقة على البقاء، والتطور، وبما يتطابق مع ذهنيتنا ورؤيتنا لأحوال بلادنا، وما نتطلع اليه جميعا بشأن واقعنا ومستقبلنا.